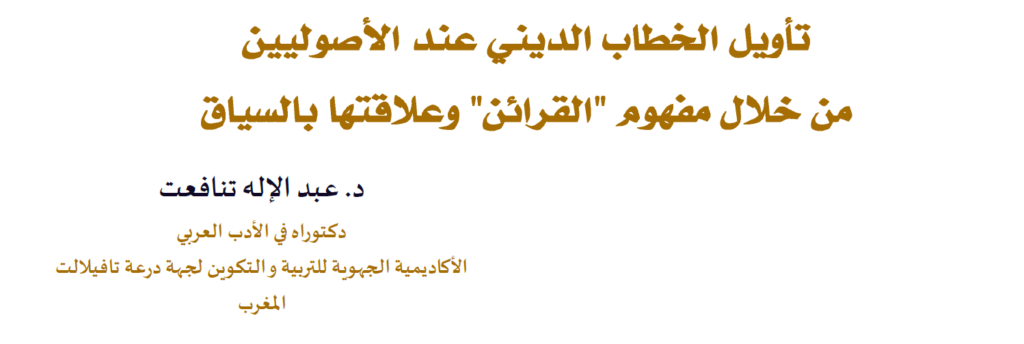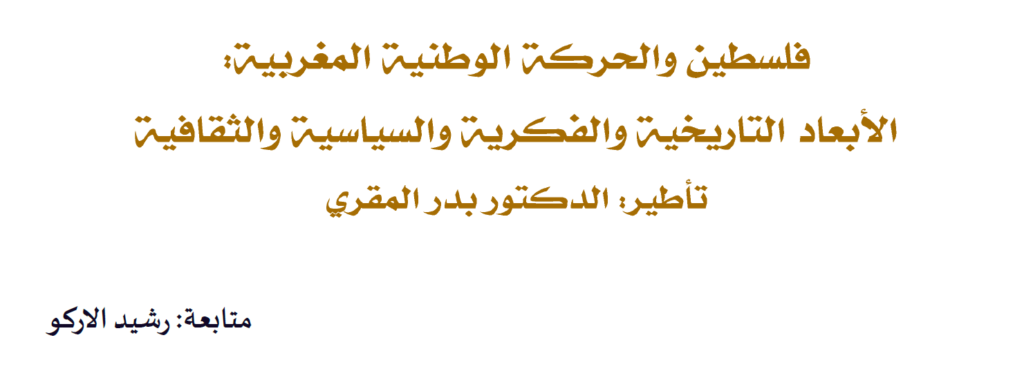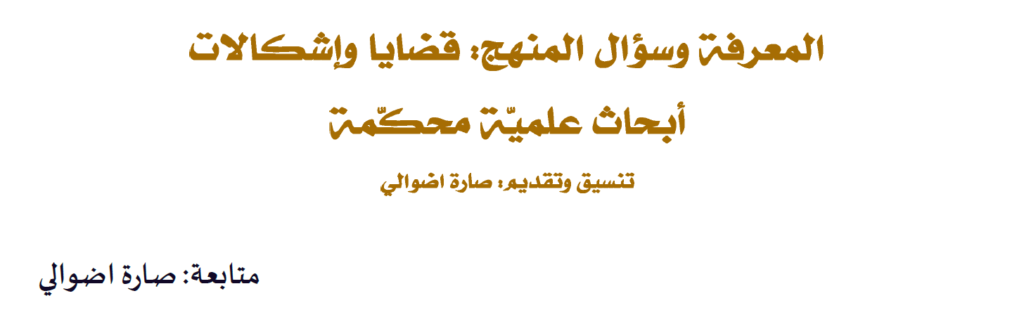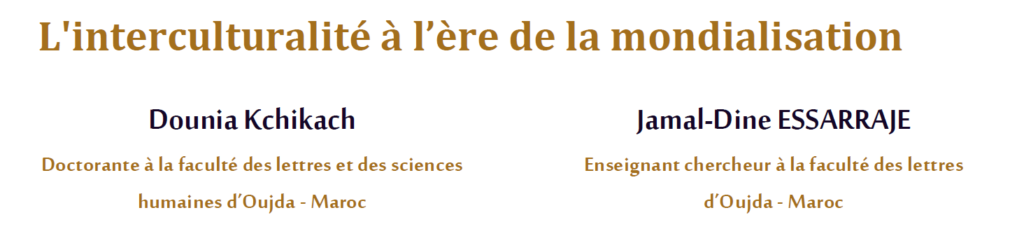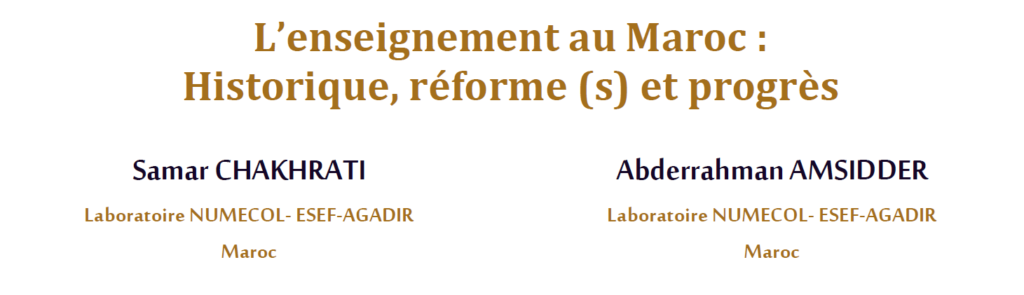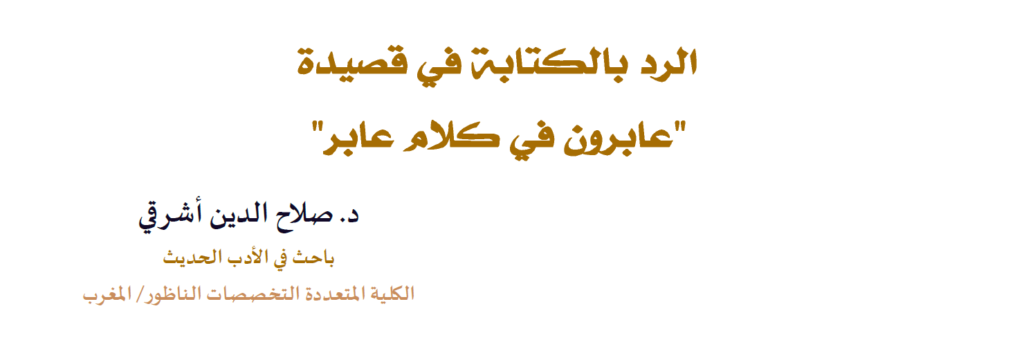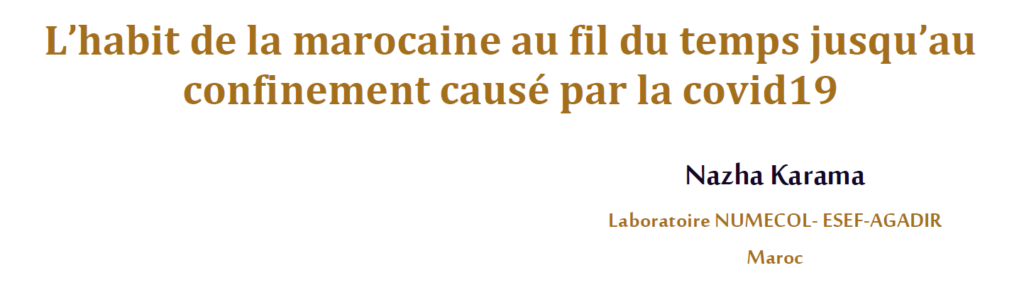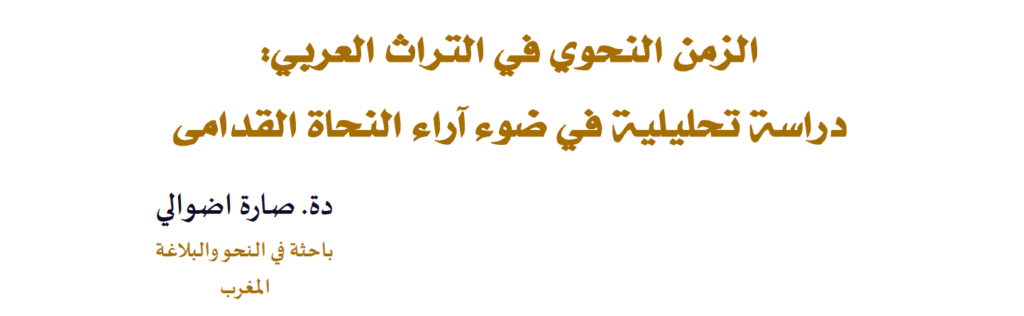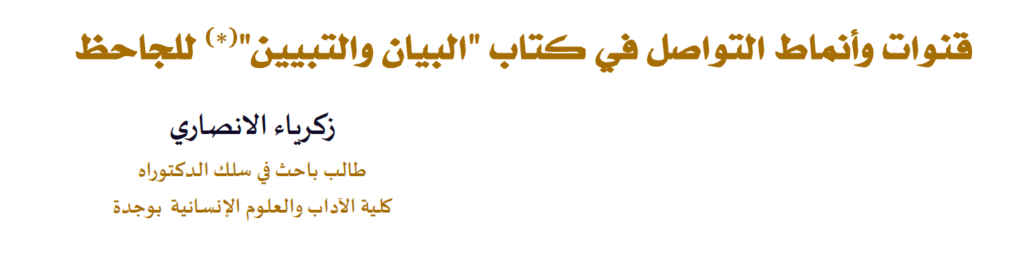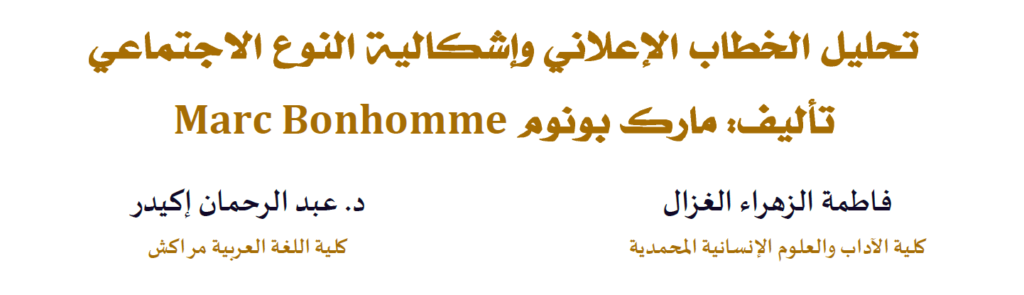تأويل الخطاب الديني عند الأصوليين من خلال مفهوم “القرائن” وعلاقتها بالسياق
لعلماء الأصول جهد معتبر في خدمة الخطاب الديني، حيث انصب اهتمامهم على دراسة مختلف مستوياته المعجمية والتركيبية، بل إن نظرهم امتد الى دراسة المستويات السياقية أو ما يعرف عندهم بالقرائن أو مقتضيات الأحوال، ويرجع اهتمامهم بهذا البعد التداولي في الخطاب الديني إلى سعيهم الحثيث إلى استنباط الأحكام الشرعية التي لا تكتسب مشروعيتها وحجيتها إلا عبر تأويله والنفاذ إلى مقصده.
وقد تنبه الأصوليون إلى منزلة القرائن وأولويتها في تحديد مقصدية الخطاب الديني، فالألفاظ إذا عزلت عن المقام لا تسعف المتلقي في معرفة المعنى المراد على وجه الدقة. ومن هنا كان استقصاؤهم لمختلف جوانب الخطاب؛ سواء تعلق الأمر بتفاعلاته الداخلية وما تفرزه من دلالة، وهو ما اصطلحوا عليه بالقرائن الداخلية، أم في علاقته بشروط إنتاجه الخارجية أو ما اصطلحوا عليه بمقام القول. وقد توخى الأصوليون من خلال القرائن إضفاء نوع من الصرامة المنهجية على تأويل الخطاب، ومنح مصداقية للأحكام الشرعية.
ويلتقي مفهوم القرائن مع مفهوم السياق في الفكر الحديث بوصفه واحدا من عوامل النشاط اللغوي الذي يجعل الرسالة تقوم بعملها وتؤدي وظيفتها، غير أن التقاطع بين المفهومين لا يلغي حدود التمايز بينهما الذي تكشف عنه طريقة اشتغال الأصوليين.
تأويل الخطاب الديني عند الأصوليين من خلال مفهوم “القرائن” وعلاقتها بالسياق قراءة المزيد »