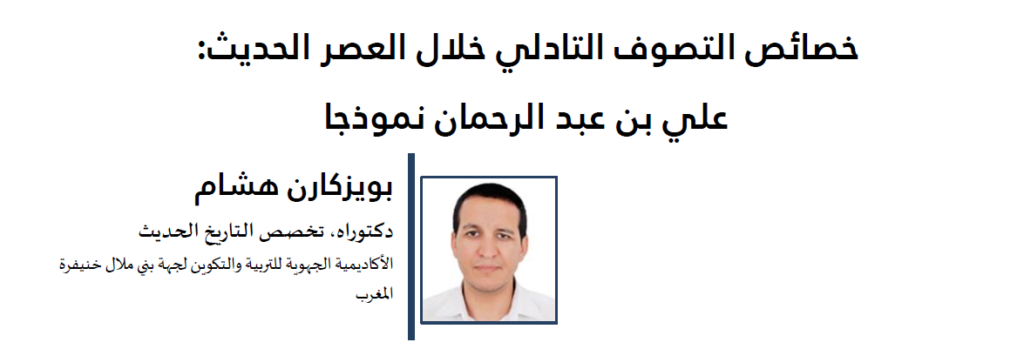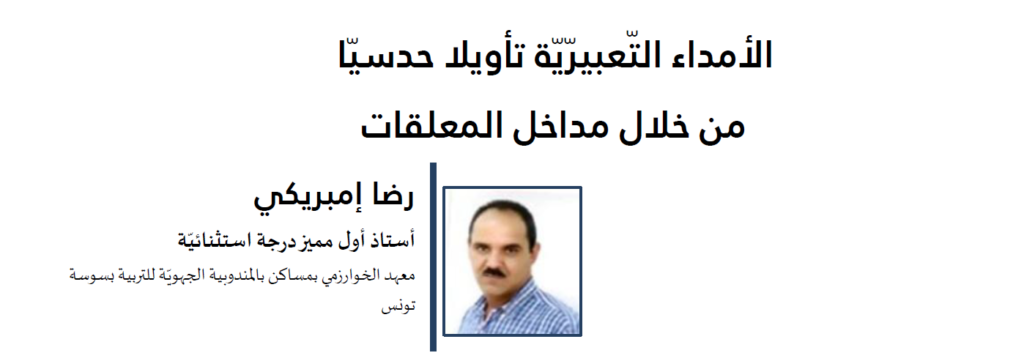تحولات معاني الأفعال في معجم الدوحة التاريخي: مقاربة معرفية
نناقش في هذا المقال ظاهرة تحول المعنى في الأفعال من خلال اعتماد متن أفعال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، فتحديد طبيعة تحول المعنى في مجال المعاجم يتطلب مراجعة لما أفرزته الأدبيات اللسانية والمعجمية من نظريات وأبحاث بخصوص تحول معاني المقولات المعجمية تزامنيا. لذلك نناقش في الفقرة الأولى من هذا المقال كيفية معالجة معجم الدوحة التاريخي للأفعال حسب اللزوم والتعدي والتعدية بحرف، وكيف يُظهر هذا التقسيم الانتقال في معاني الأفعال ذات الجذر المشترك. ونبحث في الفقرة الثانية مظاهر تحول المعنى باعتماد نموذج نحو الأبنية عند كولدبيرك (1995-2003) الذي يعالج قضية معاني الأبنية وعلاقتها باللسانيات المعرفية، وكذلك نستعين بنظرية الفاسي الفهري (2021) في المعجم العربي البنائي التنوعي، ونلخص في الأخير إلى أبرز ما تم التوصل إليه من نتائج.
تحولات معاني الأفعال في معجم الدوحة التاريخي: مقاربة معرفية قراءة المزيد »