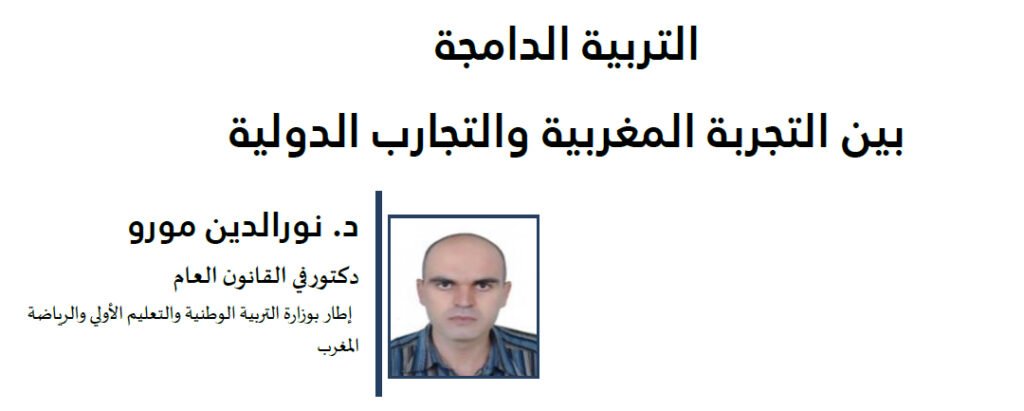القواميس العربية: النظرية والمنهج
سعى القاموسيون من خلال مؤلفاتهم العديدة إلى حفظ لغة العرب من اللحن والخطأ إضافة إلى شرح الكلمات العربية وتفسير المعاني الدالة عليها…تُنبي الصناعة القاموسية على ثلاثة عناصر الترتيب والمادة والتعريف، إذا اختفى عنصر واحد أصبح القاموس كتابا عاديا، وشأنها شأن العلوم الأخرى تقوم الصناعة القاموسية على منهج علمي رصين ومتين. ويسعى هذا البحث إلى تحديد المصطلحات القاموسية بدقة مثل التمييز بين القاموس والمعجم وكذا التمييز بين علم المعجم وصناعة القواميس، أضف إلى ذلك إبراز الاعتبارات التي على أسسها صنف الباحثون القواميس العربية.
القواميس العربية: النظرية والمنهج قراءة المزيد »