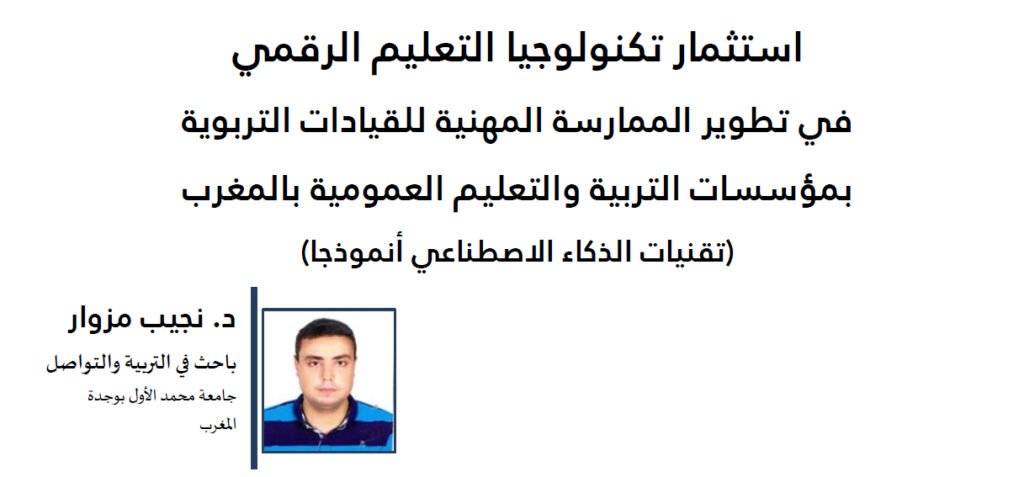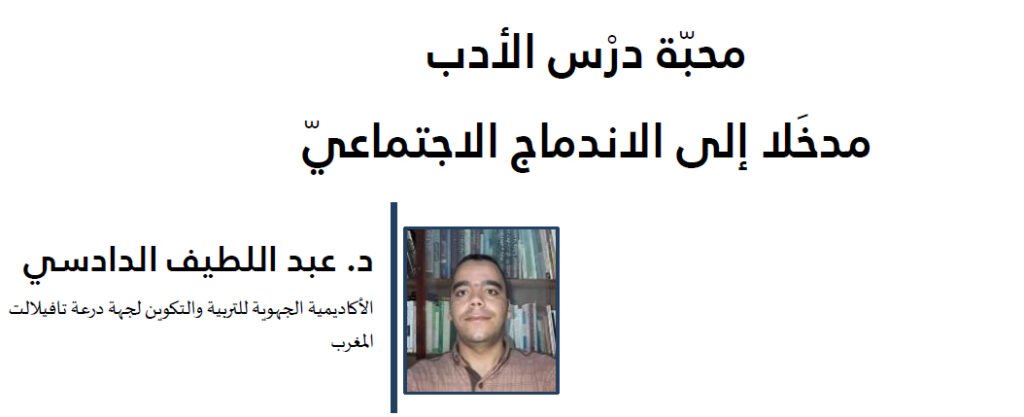تكنولوجيا التعليم وسؤال الجودة
ترمي هذه الدراسة إلى بسط الدور الذي تلعبه تكنولوجيا التعليم في إحداث نقلة نوعية متميزة في مجال التعليم، و كذا في التحصيل المعرفي لدى المتعلمين، وذلك من خلال تحديد أنماط التعليم والتعلم المرتبطة بتكنولوجيا التعليم، والبحث في الطابع المفاهيمي لكل من تكنولوجيا التعليم، والتعليم عن بعد، وكذا التعليم الإلكتروني والتعليم المبرمج، والنظر في أدوارهم ومكانتهم والتبصر في المآلات العلائقية التي تنتج عن الربط بين هذه المفاهيم على مستوى الفصل الدراسي، اعتمادا عل المنهج الوصفي والتحليلي المحكوم بضوابط اللغة ودلالات الاصطلاح وجدل العلاقات وطبيعتها.
تكنولوجيا التعليم وسؤال الجودة قراءة المزيد »