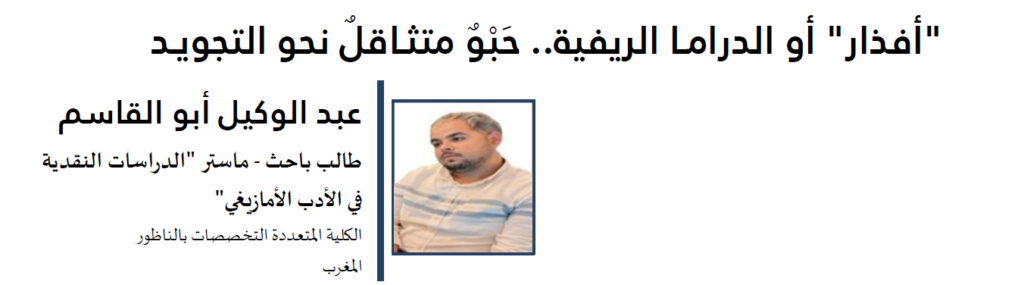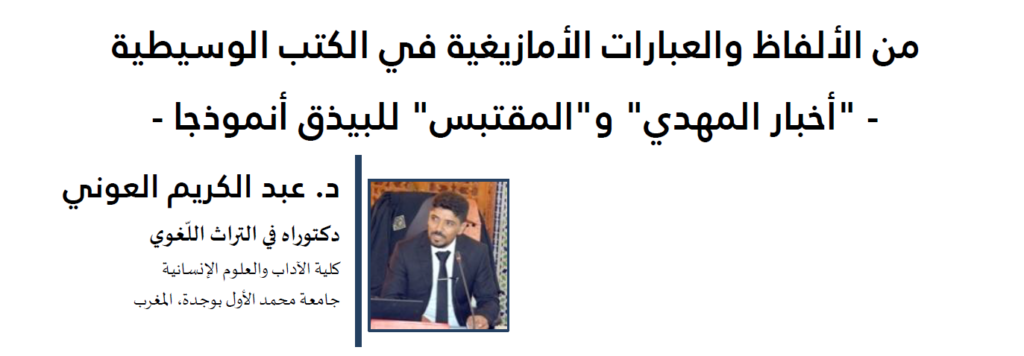“أفذار” أو الدرامـا الريفية.. حَبْوٌ متثـاقلٌ نحو التجويـد
تعد الدراما من مظاهر الأعمال التلفزية، التي تعالج قضايا اجتماعية وثقافية وغيرها، وتجذب اهتمام المتلقي. ومما يندرج، في هذا الإطار، “أفذار”؛ فهي دراما أمازيغية تطرقت إلى موضوع المرأة والتعليم ومعاناة الإنسان الريفي نتيجة غياب الجانب التنموي. ويسلط هذا العمل الضوء على حقبة زمنية محددة، هي فترة التسعينيات، متطرِّقا إلى الصعوبات الحياتية السائدة في القرى النائية آنذاك. وقد تنوعت شخصيات المسلسل؛ بحيث نجد فيه أصنافا مختلفة، تتوزع أدوارها بين الرجل الذي هيمن على أهمها. في حين اقتصر دور المرأة على أشغال المنزل، بوصفها ربة بيت. ولعل من حسنات هذا العمل إثارته هذه الصعاب والتحديات، غير أنه فنيا لم يرق – في نظرنا – إلى المستوى المنتظَر، سواء من حيث الصورة الجمالية أو المقاربة الفنية للتيمات التي عالجها.
“أفذار” أو الدرامـا الريفية.. حَبْوٌ متثـاقلٌ نحو التجويـد قراءة المزيد »