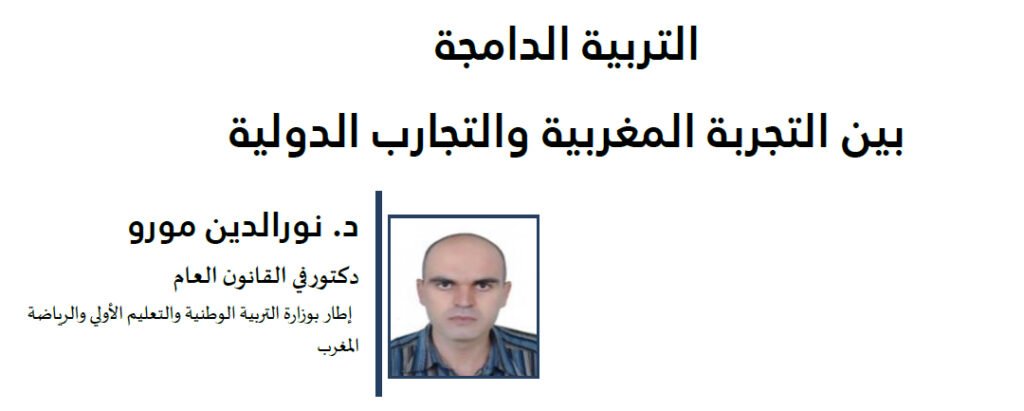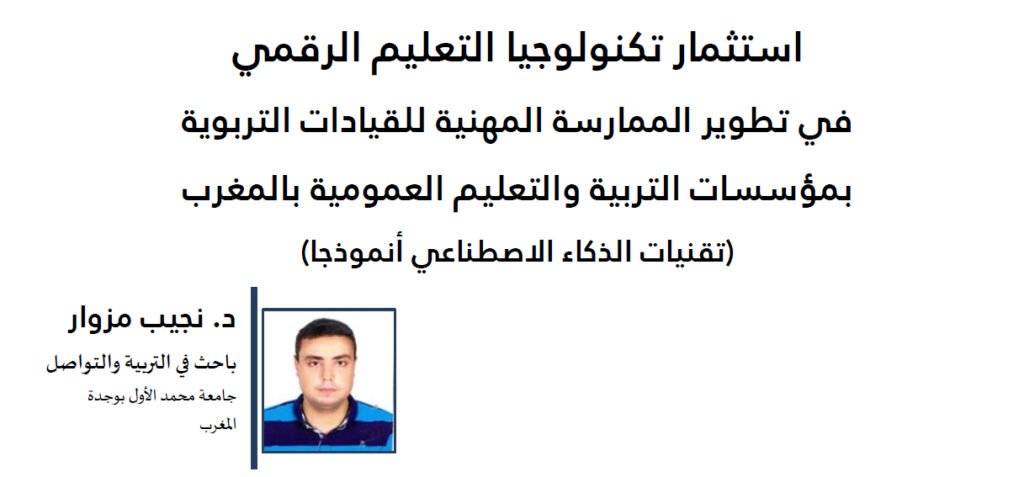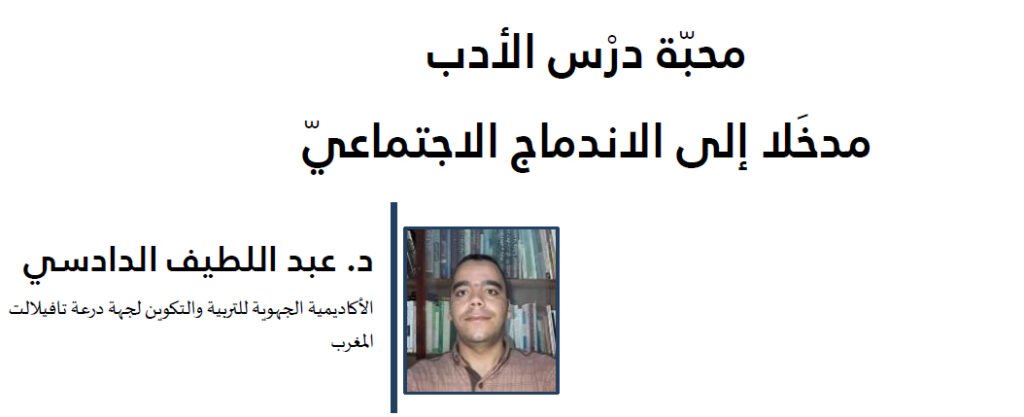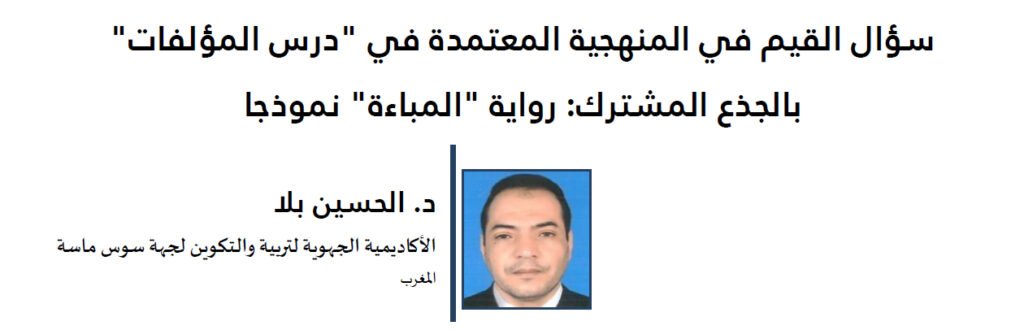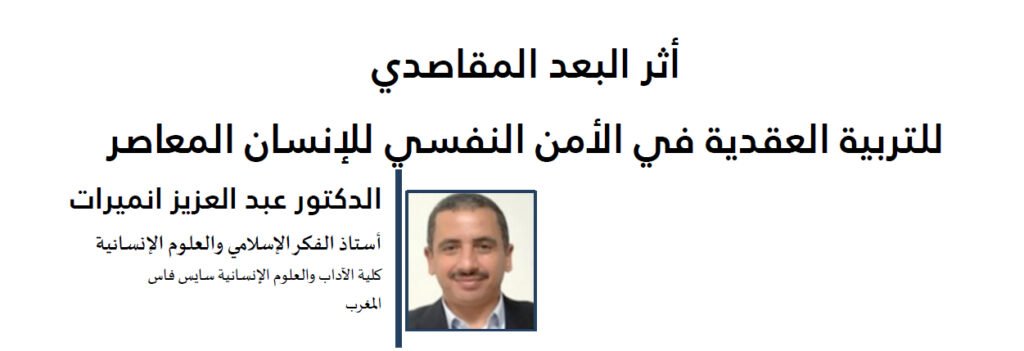مرجعيات إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بالمغرب
يعتبر موضوع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وتحسين جودة تعليمها وتعلمها في سلك التعليم الابتدائي، إحدى التحديات التي راهنت عليها وزارة التربية الوطنية بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وعملت على كسبها منذ الانطلاقة الفعلية لتدريس اللغة الأمازيغية سنة 2003. وفي هذا الإطار، تم الاشتغال على إعداد البرامج، والكتب المدرسية، والحوامل الديداكتيكية الخاصة باللغة الأمازيغية، وفق تصور نظري، يستحضر الوضع الاعتباري للغة الأمازيغية من ناحية، ويستجيب للمنطلقات والمبادئ العامة لمنهاج اللغة الأمازيغية من ناحية أخرى، إضافة إلى تكوين الأطر التربوية المعنية بتأطير وتدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها. وقد شكلت هذه المنجزات مجتمعة إحدى المداخل الأساسية لإرساء وتعميم وتحسين جودة التعلمات في اللغة الأمازيغية. شكلت عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية، ابتداء من الموسم الدراسي 2003-2004، مبادرة ذات أهمية بالغة. وخلال السنوات الخمسين الماضية، برزت مطالب الاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغيتين من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني في مختلف مناطق المغرب، وذلك في سيرورة تصاعدية ارتبطت بالعديد من المبادرات الراميّة إلى إعادة الاعتبار لهذا المكون اللغوي والثقافي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وعلى العموم، فقد استندت عملية الإدماج هذه إلى إطار مرجعي ينطلق من النص الدستوري، والخطابات الملكية، والظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والميثاق الوطني التربية والتكوين، والكتاب الأبيض، واتفاقية الشراكة بين المعهد ووزارة التربية الوطنية، والقانون الإطار 51.17، مرورا إلى خارطة الطريق 2022-2026، ثم إطار التنزيل الإجرائي 2023-2026، فضلا عن المذكرات الوزارية المنظمة. وعلى هذا الأساس سنتناول في هذه المداخلة أهم المرجعيات التشريعية والقانونية وكذا المرجعيات التربوية والتنظيمية التي تم الاستناد عليها في عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المناهج والمنظومة التربوية.
مرجعيات إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بالمغرب قراءة المزيد »