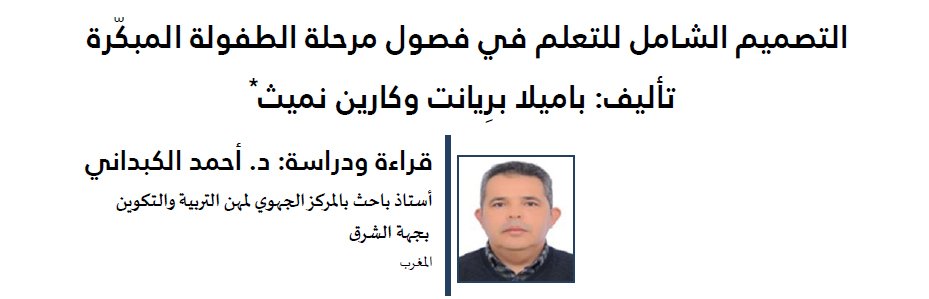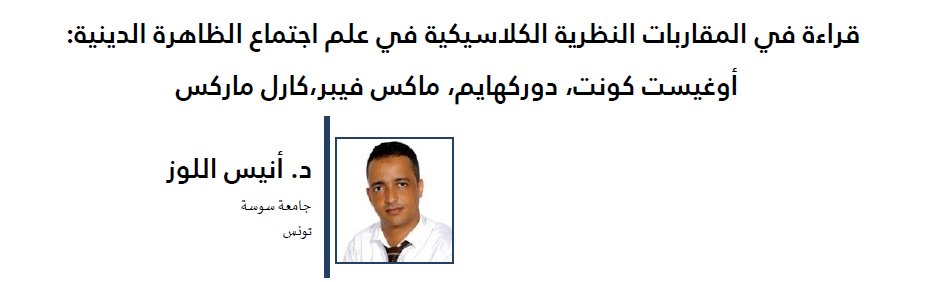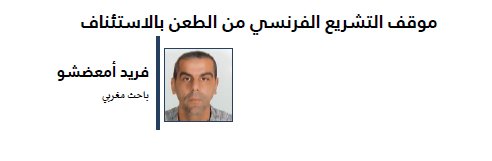مقولة الحرف بين الوظيفة النحوية والوظيفة التأويلية عند أبي القاسم السهيلي
تهدف هذه المقالة إلى دراسة مقولة الحرف باعتبارها قسما من أقسام الكلام؛ وبيان وظيفتها النحوية من جهة ووظيفتها التأويلية من جهة أخرى؛ فمقولة الحرف تحفل بمحمولات دلالية متعددة تتفرع إلى معان كلية، وإلى معان جزئية؛ استنادا ما قدمه أبو القاسم السهيلي في تحليله للأمثلة والشواهد القرآنية؛ حيث ينطلق السهيلي من التحديد النحوي لمقولة الحرف ليصل إلى تعيين الوظيفة التأويلية المرتبطة بها؛ لكن هذا لا يعني انفصال المستوى النحوي عن المستوى الدلالي التأويلي؛ بل أجد السهيلي يتوسل ببعض المبادئ المستمدة من أصول النحو سواء كانت تتعلق بأصول الرواية أو أصول الدراية؛ وذلك لخدمة الدلالات المؤولة المستنبطة من الشاهد القرآني.
مقولة الحرف بين الوظيفة النحوية والوظيفة التأويلية عند أبي القاسم السهيلي قراءة المزيد »